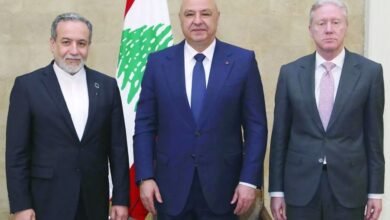خاص – بيروت بوست
في بلد تتقاطع فيه البنادق مع السياسة، وتتشابك فيه الأمنيات” مع “الأمن”، أثارت التسريبات عن اقتراح قائد الجيش العماد رودولف هيكل بتجميد عملية حصر السلاح، التي كان هو نفسه قد اقترحها وقسم مراحلها، كخطوة لبسط سلطة الدولة، تساؤلات عميقة حول الخلفيات الحقيقية والدلالات الكامنة خلف هذا الكلام المفاجئ. فهل هو “تراجع تكتيكي” أم رسالة سياسية مشفّرة في توقيت بالغ الحساسية؟
الجيش الذي حاول، عبر مبادرته، رسم حدود جديدة بين “سلاح الدولة” و”سلاح الفصائل”، وجد نفسه أمام جدار من الاعتراضات السياسية والطائفية، في الداخل، وتشدد اميركي – اسرائيلي، سرعان ما حوّل المبادرة إلى كرة نار.
فبعض القوى قرأت فيها محاولة “تقليم أظافر” المقاومة، فيما رآها آخرون سعياً لاستعادة هيبة الدولة التي تآكلت على مرّ السنوات. لكنّ تجميدها اليوم، كما تقول مصادر مطلعة، لا يعني بالضرورة طيّ الصفحة، بل إعادة تموضع في مقاربة الملف الأمني بما يتناسب مع التوازنات الدقيقة في البلاد.
سياسياً، يعكس القرار، في حال صحت المعلومات، إدراك المؤسسة العسكرية أنّ ملف السلاح لا يُدار بالنيات، ولا بالقرارات التقنية، بل هو جزء من منظومة توازنات إقليمية ومحلية شديدة التعقيد. فلبنان، الغارق بين خطوط تماس داخلية وتقاطعات إقليمية، لا يحتمل اليوم أي هزّة في معادلة “الجيش ـ الشعب ـ المقاومة”، التي تُعدّ بالنسبة إلى شريحة واسعة من اللبنانيين صمام أمان، وبالنسبة إلى خصومها عنواناً للاختلال السيادي، خصوصا ان العهد الحالي برئاسته وقيادة جيشه “اولاد” هذه المعادلة، وانبثقوا من رحمها.
في العمق، قد يكون “تجميد الخطة”، اذا ما قرر، بمثابة خطوة استباقية لتجنّب تفجير الساحة الداخلية في مرحلة يغيب فيها الغطاء الوطني عن الجيش، ويتراجع فيها الدعم الدولي بفعل “الدولة النايمة” والانقسام الداخلي. فالجيش، الذي يقف على تماس مع جميع الأطراف، يدرك أنّ أي تحرك باتجاه “نزع السلاح” خارج توافق وطني شامل، سيضعه في مواجهة مباشرة مع قوى تمتلك شرعية شعبية وسياسية، وهو ما يسعى لتفاديه حفاظاً على وحدة المؤسسة وصورتها الوطنية، تحديدا بعد وضع حزب الله خطوطه الحمر.
أما على المستوى الأمني، فالتجميد لا يعني غياب المتابعة. فالمؤسسة العسكرية تواصل مراقبة حركة السلاح غير الشرعي الفلسطيني وغيره، ضمن حدود الممكن، من دون أن تُستدرج إلى معركة سياسية لا تملك ترف خوضها الآن. فالأولوية، وفق مطلعين، هي منع الانفجار الاجتماعي والأمني، لا الدخول في صراعات توازن القوة.
لكن ماذا عن رد فعل واشنطن؟
اكيد أن اتخاذ هكذا قرار لن يمرّ بصمت في أروقة واشنطن، خصوصاً لدى دوائر وزارة الخارجية والحرب، اللتين تعتبران الجيش اللبناني آخر “ممرّ آمن” لنفوذ الأميركي في بلد يتنازعه المحوران الإيراني والغربي.
وبحسب مصادر أميركية، فإنّ واشنطن لن تُعلن اعتراضاً صريحاً على التجميد، لكنها ستوجّه رسائل “باردة” عبر القنوات العسكرية والديبلوماسية، مفادها أنّ الدعم الأميركي المستمر للجيش مشروطٌ بالحفاظ على مسافة واضحة من سلاح حزب الله وبالسير في اتجاه “تعزيز احتكار الدولة للقوة”. بمعنى آخر، سترفع مستوى التدقيق والمراقبة على صعيد المساعدات.
في المقابل، تدرك الإدارة الأميركية أنّ أي ضغط مفرط على الجيش قد يرتدّ سلباً ويضعفه أمام الداخل اللبناني، لذا يُتوقّع أن تعتمد سياسة العصا والجزرة: استمرار الدعم اللوجستي والإنساني، مقابل تلميحات بأنّ “الإصلاح المؤسسي” في المؤسسة العسكرية شرطٌ لاستمرار التمويل، لا سيما بعد ملاحظات الكونغرس على الشفافية في بعض بنود المساعدات.
من الزاوية السياسية، سيُقرأ التجميد في واشنطن كإشارة إلى أنّ الجيش اختار الحياد التكتيكي في صراع داخلي لا يريد التورط فيه. وهذا بالنسبة للأميركيين، وإن كان محبطاً، يبقى مقبولاً طالما أنّ المؤسسة لا تنزلق إلى محور طهران.
لكن خلف الكواليس، ثمّة قلق متزايد من أن يؤدي هذا التراجع إلى تعزيز دور حزب الله كقوة أمر واقع، ما قد يدفع مراكز الضغط في الكونغرس إلى المطالبة بإعادة تقييم المساعدات أو إعادة توجيهها نحو قطاعات “أكثر استقلالاً”، مثل قوى الأمن الداخلي أو مؤسسات المجتمع المدني ذات التمويل الغربي.
وفي التوقيت، قد تستغل واشنطن هذه الخطوة كورقة في مقاربتها الأشمل للملف اللبناني، في ضوء تحركاتها الأخيرة لإعادة رسم حدود النفوذ في الشرق الأوسط بعد حرب غزة واتفاقات الأمن الإقليمي. أي أنها ستتعامل مع التجميد كجزء من معركة النفوذ الناعمة بين طهران وواشنطن على أرض الأرز.
في الخلاصة، لا يمكن قراءة قرار تجميد خطة “حصر السلاح” كإخفاق، بقدر ما هو تعبير عن واقعية في بلد يحكمه ميزان دقيق بين الممكن والممنوع.
إنه أشبه بوقف ساعة موقوتة قبل أن تدقّ. فلبنان اليوم لا يحتمل كسر توازناته بنظر بعبدا واليرزة، والجيش الذي يعي ذلك جيداً، اختار أن يجمّد المبادرة …. ومعها دوره ….